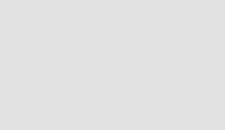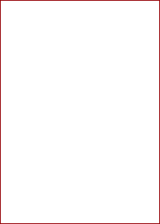تتداخل في اشكالية فصل الدين عن الدولة اعتبارات شتى، منها ما هو استمولوجي يتعلق بطبيعة المعرفة العملية، من جهة، وطبيعة المعرفة الدينية، من جهة ثانية، على افتراض امكانها. ومنها ما هو معياري يتعلق بطبيعة القيم السياسية، بخاصة. ومنها ما هو مفاهيمي يتعلق بطبيعة الدين وطبيعة السياسة. وقد تناولت في عدد من مؤلفاتي السابقة كل هذه الاعتبارات، بكل تداخلاتها، وبالطبع لا يسمح الوقت المخصص لمحاضرتي بايفائها جميعها حقها من البحث. ولذلك سأركز في حديثي اليكم هذا المساء على قضية واحدة أساسية، ألا وهي أهمية فصل الدين عن الدولة لغرض اقامة مؤسسات ديمقراطية حقة. لا أفترض هنا أن هناك علاقة منطقية بين الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة. موقفي هو أن العلاقة بين الديمقراطية الحقة والعلمانية هي علاقة موضوعية. وهذا يعني أن هناك اعتبارات واقعية شتى تتعلق بالطبيعة البشرية وطبيعة المجتمع الانساني، وبنظرة البشر الى عقيدتهم الدينية وما يعنيه كل هذا، عمليا ً وواقعياً، اعتبارات تجعل من المتعذر تعايش الديمقراطية مع اللاعلمانية. اذن، التحدي الذي يواجه الديمقراطية جراء عدم فصل الدين عن الدولة هو تحد لا يجوز مطلقا ً الاستخفاف به.
كثيرة طبعا ً هي التحديات التي تواجه الديمقراطية، ولكنها جميعها تهون ازاء التحدي الذي يمثله تسييس الدين لغرض اقامة دولة دينية. اللامبالاة، مثلا ً، قد تضعفها، اذ تحول دون تحويلها الى ديمقراطية مشاركة. ووجود العديد من الجماعات ذات المصالح الجزئية المتعارضة قد يشل الجسم السياسي، اذ يؤثر على فعالية المؤسسات الديمقراطية وآليات صنع القرارات الجمعية بصورة سلبية. ووجود أكثرية اثنية أو دينية مصرة على الاستئثار بالسلطة قد يمسخ النظام الديمقراطي، فينتج عن تطبيق مبدأ حكم الأغلبية ما دعاه توكفيل "طغيان الأكثرية". وغياب العدالة الاجتماعية، كما نعرف من خلال تفحصنا للأنظمة الديمقراطية في الغرب الرأسمالي، قد يدفع بالديمقراطية في اتجاه ما يماثل الأوليغاركية، اذ يعطي لقلة من أصحاب المال والنفوذ وزنا ً سياسيا ً يفوق بما لا يقاس ما يتناسب مع مستلزمات العدالة السياسية. ولكن أين هذه التحديات من التحدي الذي يمثله تسييس الدين لغرض اقامة دولة دينية، حيث الدين الذي يجري تسييسه لهذا الغرض هو دين الأكثرية؟ فكل تحد من التحديات السابقة يشكل، في أسوأ حال، تهديدا ً لمقوم أو آخر من مقومات الديمقراطية. أما التحدي الذي يمثله تسييس الدين، فانه، لو تحقق الغرض منه، لا بد أن ينتهي، عمليا ً وواقعيا ً، الى تقويض كل مقوم من مقومات الديمقراطية، أو القضاء على أي أمل، في مجتمعات غير ديمقراطية، كالتي بين ظهرانينا، في اقامة نظام ديمقراطي حقيقي.
يتخذ هذا التحدي مغزى خاصا ً لنا، نظرا ً لان تسييس الدين يقوم على النظر الى الاسلام على أنه دين ودولة. صارت هذه النظرة الى الاسلام شبه مسلمة، حتى من قبل أفراد لا تربطهم بالاسلام السياسي أي رابطة. والأسوأ من كل هذا أن الذين يتبنون هذه النظرة ويعملون بوحيها صار لهم تأثيرهم الواسع في المجال العام، وصاروا يشكلون في بعض أقطارنا البديل للأنظمة الاتوقراطية القائمة نظاما ً ديمقراطيا ً يقوم على الارادة العامة، فان هذا البديل يكاد أن يكون نظاما ً لا علمانيا ً لا تقيد فيه الحريات السياسية فحسب، كما هو الحال في الأنظمة الأوتوقراطية القائمة بين ظهرانينا، بل تقيد فيه كل الحريات، بما في ذلك الحريات الشخصية، مما ينتهي الى تحقيق شبه تماد بين المجالين الخاص والعام.
لن أتعرض هنا للنظرة الى الاسلام التي تجعل السياسة شيئا ً في صلب عقيدته، اذ تعرضت لها في العديد مما نشرته سابقا ً، محاولا ً اظهار فسادها وتناقضاتها. ما يعنيني هنا هو أن أبين أن العلمانية شرط لا غنى عنه لبناء نظام ديمقراطي سليم. ولذلك سأبدأ بتناول مفهوم الديمقراطية والمبادىء التي ينطوي عليها، لأعمل من ثم على تبيان التعارض بين هذه المبادىء ومستلزمات الموقف اللاعلماني.
لا يجوز الاستنتاج من كلامي أن الأنظمة العلمانية أنظمة ديمقراطية بالضرورة. ان موقفي لا يتضمن أكثر من القول ان الأنظمة اللاعلمانية هي أنظمة غير ديمقراطية بالضرورة. فالعلماني قد يذهب الى حد المطالبة بعلمنة تامة للمجتمع، كما حصل في الاتحاد السوفييتي، مثلا ً، مما يعني اقامة نظام تقيد فيه، بل تلغى عمليا ً، حرية الاعتقاد الديني، ولا أظن أن نظاما ً كهذا، حتى وان لم يتجاوز الغاء حرية كالأخيرة، يمكن أن يعد بحق نظاما ً ديمقراطيا ً. ولكن حتى لو لم تمس حرية الاعتقاد الديني في النظام العلماني، فان هذا النظام قد يكون نظاما ً كليا ً أو نظاما ً ديكتاتوريا ً، كما نعرف من مثالي النازية والفاشستية. ولكن من الواضح أن النظام العلماني قد يكون ديمقراطيا ً، خصوصا ً وان لم يتجاوز علمنة السياسة، بكل ما يعنيه هذا من تقليص لدور الدين في المجال العام. ولكن لا يمكن للديمقراطية، كما سأبين، أن تتعايش مع تسييس الدين وجعل الاعتبارات الدينية الأساس الذي تقوم عليه القوانين والتشريعات، بل لا يمكن أن تتعايش حتى مع تفشي النزعة في المجال العام نحو جعل الاعتبارات الدينية، لا ما صار يعرف ب"العقل العام"، المعيار لتقويم السياسات والتشريعات – هذه النزعة التي تترجم عمليا ً الى حركة سياسية مبتغاها تأسيس الدولة على الدين.
من المسائل التي ينبغي التنبيه اليها في البداية مسألة أن النظام اللاعلماني قد لا يتعارض مع الديمقراطية بمعناها الاجرائي، ولكنه حتما ً يتعارض مع اقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة. التركيز هنا هو على عدالة المؤسسات، اذ لا يبدو أن هناك علاقة مفهومية بين الديمقراطية والعدالة. مما يعني أنه يمكن، من حيث المبدأ، أن تكون دولة ديمقراطية وغير عادلة. ولكن، بحسب فهمي، الديمقراطية، غير مقرونة بالعدالة، وان كانت قابلة للتصور، الا أنها ديمقراطية في الشكل لا الجوهر. انها، في أفضل حال، ديمقراطية اجرائية. ولذلك ما أريد التركيز عليه هنا هو السؤال، هل تسييس الدين، بما ينطوي عليه من أغراض، يتفق ليس فقط مع مستلزمات الديمقراطية، بمعناها الاجرائي، بل مع مستلزمات الديمقراطية، بمعناها الجوهري، أي من حيث كونها تتجسد مؤسسات عادلة؟ لن أتناول العدالة هنا بمعناها السياسي، اذ ليس ثمة شيء في الغرض من تسييس الدين أو اقامة نظام لا علماني ما يتعارض بالضرورة مع العدالة الاقتصادية.
لا بد، اذن، أن نبدأ بابداء بعض الملاحظات حول معنى ومستلزمات المؤسسات الديمقراطية العادلة. من المفيد التركيز الآن على ما يكمن في صميم هذه المستلزمات، وأعني التعددية.
كثيرة هي النظريات التي تعالج التعددية، ولكن سأكتفي بتناول ثلاث منها باختصار، وهي: النظرية الكلاسيكية في التعددية؛ والنظرية الراديكالية؛ والنظرية الليبرالية. يركز التعدديون الكلاسيكيون، من أمثال روبرت دال وسيمور مارتن لبست، على الصراع بين الفئات ذات المصالح المتعارضة في المجتمعات الحديثة. ولكن هذا يصدق أيضا ً الى حد كبير، على التعدديين الراديكاليين، من أمثال روبرت دال وسيمور مارتن لبست، على الصراع بين الفئات ذات المصالح المتعارضة في المجتمعات الحديثة. ولكن هذا يصدق أيضا ً الى حد كبير، على التعدديين الراديكاليين، من أمثال شنتال موف، وأرنستو لاكلو، وكلود لوفور، ووليم كونلي. ما يميز بين هذين الفريقين من التعدديين هو أن الكلاسيكيين يجدون في الصراع مشكلة لا بد للديمقراطية من مواجهتها، وما يشكل محور اهتمامهم، لذلك، هو ايجاد طريقة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات التي تجري ضمنها شتى الصراعات بين الفئات ذات المصالح المتعارضة. أما الراديكاليون، بالمقابل، فانهم لا يجدون في الصراع مشكلة للديمقراطية بل فضيلة من فضائلها، ومأسسة هذا الصراع، في نظرهم، هي من العوامل التي قد تضمن عدم تحول النظام الديمقراطي الى نظام أتوقراطي.
اذا كانت النظرية الكلاسيكية تفهم هذا الصراع فهما هوبزيا ً (نسبة لتوماس هوبز)، فان الراديكاليين، بالمقابل، يستعينون بشكل واضح بمفهومات مستمدة من فلاسفة ما بعد حديثين، من أمثال ليوتار وفوكو ودريدا. ولكن على الرغم من الفرق بينهما، فان النظريتين تزوداننا بفكرة مشتركة من الصعب اغفالها، ألا وهي أن المجتمعات الحاضرة، مهما كانت متجانسة، مخترقة بالتعددية على شتى المستويات، اذ نجدها منقسمة داخليا ً على أساس طبقي، وطائفي، وجنسي، واثني... الخ.
النظرية الليبرالية في التعددية هي، على نحو أو آخر، محاولة لتسويغ وضع قيود على السلطة السياسية، بحيث يضمن ذلك المحافظة على الحريات الأساسية، كحرية الضمير، وحرية الفكر والشعور، وحرية الرأي، وحرية الفرد في أن يختط بنفسه الطريق التي يراها مناسبة لحياته، وفي أن يجتمع مع سواه لأي غرض مشروع. ما هو مشترك بين الليبراليين، على مختلف توجهاتهم الفلسفية، هو اصرارهم على ضرورة وضع حد فاصل بين المجال العام والمجال الخاص. ولكن قد تنشأ شتى الخلافات بينهم حول أين يجب وضع هذا الحد الفاصل، وما ينبغي استبعاده أو عدم استبعاده من فئة الحريات الأساسية، وما اذا كان فهم الحرية ينبغي الا يتجاوز فهمها سلبيا ً. ولكن ثمة فكرتين أساسيتين مشتركتين بين الليبراليين المعاصرين، وهما، أولا ً، فكرة وجود رباط حميم بين الليبرالية والديمقراطية؛ وثانيا ً، فكرة كون التعددية من طبيعة القيم.
لتناول، أولا ً، الفكرة الأخيرة. ما يمكن اعتباره موقفا ً معقولا ً هنا، من وجهة نظري، بدون الحاجة الى احتضان موقف شكوكي ازاء القيم، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الليبراليين، هو أن هناك عقائد شاملة ذات طبيعة ميتافيزيقية أو دينية تمثل منظورات قيمية مختلفة وتنطوي، بالتالي، على تصورات مختلفة للخير. قد لا يوجد تناسب بين هذه التصورات المختلفة، كما يعتقد أشعيا برلين، مما يعني أنه لا يمكن المفاضلة بينها على أساس عقلي. ولكن حتى لو لم نجار برلين في اعتقاده هذا، فان ما يمكن تسويغه هنا هو أن العقائد الشاملة المعنية في هذا السياق لا يخضع الاختيار بينها لاعتبارات عقلية، وأن الوصول الى اتفاق حول أيها صحيح غير ممكن الا عن طريق انقلاب فكري جماعي أو "وثبة ايمان" جماعية، والا فانه يكون نتيجة فرض جماعة موقفها على الجماعات الأخرى التي لا تشارك السابقة اعتقادها. بمعنى آخر، ان اتفاقا ً كهذا، ان حصل، فانما يحصل اما بأعجوبة وليس نتيجة تفاعل حواري يقوده العقل، أو يكون مفروضا ً. وما يتبع من هذا هو أن القيم التي تنطوي عليها أي عقيدة من هذه العقائد الشاملة، لأنها جزء متمم للنسق المفاهيمي لهذه العقيدة، تتخذ طابعا ً غير عقلي (ولا أقول لا – عقلي) شأن هذه العقيدة الشاملة نفسها.
ما تنطوي عليه تعددية القيم هو أن القيم لا يمكن وضعها في هرمية منظمة ميتافيزيقيا. وهذا يعني أنه يمكن أن توجد عدة تصورات معقولة للخير، مما يفسر لماذا الحكم والاختيار الفرديان في مجال القيم هما من الأهمية بمكان، بحيث يصدق على الشخص الذي يحكم ويختار أنه يقترب من النموذج الفرد المستقل بذاته، كما تصوره منط في فلسفته الأخلاقية. ان هذا، ولا شك، يستوجب المساواة الأخلاقية بين جميع الأشخاص من حيث كون كل منهم كائنا ً مستقلا ً بذاته. لا يجوز للدولة، في هذه الحالة، أن تخضع لنفوذ أي عقيدة من العقائد الشاملة المعنية، وأن تنحاز لتصور الخير الذي تنطوي عليه هذه العقيدة. فان هذا لا يمكن أن يعني عمليا ً سوى مأسسة قيم الجماعة التي تتبنى هذه العقيدة وفرضها على الجماعات الأخرى. وبهذا تنزلق الدولة نحو الأبوية، متدخلة بصورة غير مشروعة في حياة الفرد، فارضة عليه أن يرى الخير كما تراه هي وليس كما يراه هو بنظرته الخاصة.
من هنا اصرار الليبرالي على ضرورة التزام الدولة الحياد ازاء التصورات المختلفة للخير. فان معاملة الأشخاص على النحو الذي يستلزمه كون كل منهم ذاتي الاستقلالية يستوجب رفض النزعة الأبوية والنزعة الكمالية معها، فتبقى للفرد الحرية الكاملة في أن يختار قيمه. والحياد ازاء التصورات المختلفة للخير هو بالضرورة حياد ازاء العقائد الشاملة التي تشكل الأساس لهذه التصورات المختلفة. فما يصدق على هذه التصورات لجهة كونها تخضع للحكم والاختيار الشخصيين، انما يصدق بصورة أقوى على العقائد الشاملة هذه. فاذا كان يصدق على القيم أنه لا يمكن وضعها في هرمية مرتبة متيافيزيقيا، فان هذا يصدق من باب أولى على العقائد الشاملة. اذن يمكن، من حيث المبدأ، وجود عدة عقائد معقولة كهذه.
لا يمكن، بالنسبة لليبرالي، فصل مبدأ الحياد، من حيث كونه ذا أهمية لمسألة التعددية، عن فكرة أسبقية الحق على الخير. فهذا المبدأ يفرض الفصل بصورة واضحة بين الخاص والعام، مما يستلزم ألا تخضع للسلطة السياسية سوى الأفعال التي يمكن أن تكون ذات نتائج تطال عدالة العلاقات الاجتماعية. وهذا يعطي في المجال العام للقواعد المحافظة على العلاقات الاجتماعية الأولية على القواعد التي يعني التقيد بها تحقيق الخير وفق تصور معين له ولا يمكن، بالتالي، الاجماع حوله.
لا يقوم مبدأ الحياد على مبدأ احترام الاستقلالية الشخصية وحده، بل انه يقوم أيضا ً على مبدأ الاحترام المتبادل. يمكننا هنا وضع المبدأ الأخير على النحو التالي: على افتراض وجود عدة عقائد شاملة، حيث تكون الأسس لكل عقيدة منها غير شفافة للذين لا يعتنقون هذه العقيدة، فان أصحاب كل عقيدة من هذه العقائد ملزمون باحترام السلطة المعرفية لأصحاب العقائد الأخرى، فيما يخص ما يرونه بنظرتهم الخاصة على أنه حق أو خير أو ذو قيمة. ان هذا المبدأ يستلزم، اذن، المساواة المعرفية بين جميع الفرقاء وينفي، بالتالي، أن يكون لأي منهم امتياز معرفي في المجال الذي يعنينا هنا. كل فريق، ولا شك، سيدعي لنفسه امتيازا ً معرفيا ً، وسيرفض التخلي عن سلطته المعرفية لأي فريق آخر، مما يعنى أنه من غير المحتمل أن ينجح أي فريق في جعل سلطته المعرفية هي السلطة النافذة في المجتمع بأكمله، الا عن طريق فرضها على جميع الفرقاء، على افتراض أن الفرصة متاحة له لفعل ذلك. من هنا يتضح أن الاحترام المتبادل هو البديل الوحيد العادل والمنصف الذي ينبغي أن ينظم على أساسه تعامل الفرقاء بعضهم مع البعض الآخر. رفض هذا البديل هو بمثابة رفض مبدأ القابلية للكوننة. ما يثبته المبدأ الأخير هو التالي: بالنسبة لأي م (حيث م هو متغير يمكن أن نستبدل به فعلا ً ما أو طريقة ما في التعامل أو سياسة ما)، اذا افترضنا أن مبدأ ما يكفي لتسويغ م، اذن يتبع من ذلك أن هذا المبدأ اياه يكفي أيضا ً لتسويغ أي شيء آخر شبيه ب م بالنسبة لكل السمات المجردة ل م. ما يتضمنه هذا، في السياق الحالي، هو أنه اذا كان ثمة مبدأ لتسويغ رفض معتنقي أي عقيدة من العقائد الشاملة المعنية التخلي عن سلطتهم المعرفية لأصحاب أي عقيدة أخرى، اذن هذا المبدأ اياه لتسويغ رفض الأخيرين التخلي عن سلطتهم المعرفية للسابقين.
من الواضح الآن لماذا يقود رفض مبدأ الاحترام المتبادل الى رفض مبدأ القابلية للكوننة. فما يتضمنه رفض مبدأ الاحترام المتبادل هو أن الفريق الرافض له يفترض أن من حقه أن يحل سلطته المعرفية محل السلطة المعرفية لسائر الفرقاء، على الرغم من أنه يرفض أن يكون لأي فريق آخر الحق نفسه ما يرضاه لنفسه لا يرضاه لسواه. ولكن اذا كان مبدأ القابلية للكوننة يؤسس حق كل فريق، في وضع من المساواة المعرفية، في أن يرفض التخلي عن سلطته المعرفية لأي فريق آخر، اذن فانه ينكر على أي فريق الحق في أن يطلب من الآخرين التخلي عن سلطتهم المعرفية له.
اذا كان لا مفر، على المستوى المعياري، من تبني مبدأ الاحترام المتبادل، اذن لا مفر أيضا ً من تبني مبدأ الحياد في المجال العام ازاء العقائد الشاملة. فلو قامت الدولة، مثلا ً، بالترويج لعقيدة من هذه العقائد دون سواها، فان هذا سيكون بمثابة خرق لمبدأ القابلية للكوننة، أي بمثابة حض لأصحاب العقائد الأخرى على التخلي عن سلطتهم المعرفية لأصحاب العقيدة التي تروج لها الدولة. ولكن هذا، كما رأينا، يتعارض مع مبدأ الاحترام المتبادل. من الواضح، اذن، أن الضرورة المعيارية للمبدأ الأخير ينبغي أن تترجم الى حياد من قبل الدولة ازاء العقائد الشاملة المتعددة.
اذا كانت التعددية توجب أن تكون للعدالة السياسية الأولية (أي أن تكون للحق الأولية على الخير)، فان العدالة السياسية بدورها توجب أن تكون للديمقراطية الأولية على كل الأنظمة السياسية المنافسة. نجد هنا الرباط الحميم – ولا أقول المفهومي – بين الليبرالية والديمقراطية. ان الاجراءات الديمقراطية، حسب هذا الفهم، لن تكون مجرد اضافة الى مجتمع تحققت فيه من قبل شروط العدالة السياسية، أي ميكانيزم اضافي لتجميع التفضيلات في المجتمع، بل انها ستكون بالأحرى جزءا ً لا يتجزأ من المؤسسات العادلة. فان ايجاد الطرق الفعالة في تسهيل التفاعل الحواري بين المواطنين والمشاركة الفردية والجماعية في الحياة العامة، وغير ذلك مما يتصل بحرية القول وحرية العمل، هي شيء ضروري لتبلور مبادىء العدالة ولوضعها موضع التنفيذ. بدون افساح المجال لأصوات فعلية تمثل منظورات مختلفة لأن تعبر عن المصالح المحددة والقيم والهويات والتجارب العينية التي يتكون منها العالم الاجتماعي، بكل ما في داخله من تعدد وتنوع، لا يمكن ايجاد طريقة فعالة للمجيء بالمعايير المطلوبة لتنظيم سيرورة التفاعل الاجتماعي الحواري بين ممثلي مختلف المصالح والمنظورات القيمية والهويات. في غياب أصوات كهذه، أو في غياب الشروط الضرورية لسماعها، فان المبادىء المعيارية التي ستنظم العلاقات الاجتماعية على أساسها، في هذه الحالة، ستكون معرضة لاتخاذ طابع استبعادي وغير عادل.
التعددية هي الحد الأوسط بين العدالة والديمقراطية. ففي غياب التعددية في المصالح والهويات والمنظورات القيمية، لا تعود مسألة عدالة أو عدم عدالة المؤسسات الديمقراطية مسالة مطروحة. ان هذا واضح من كون افتقار المؤسسات الديمقراطية الى العدالة يعني تجسيدها لسياسات استبعادية. ولكن سياسات كهذه ممكنة فقط اذا كان ثمة شيء يمكن استبعاده. اذن، على افتراض وجود مجتمع غير تعددي، بالمعنى الخالص، فلا حاجة للديمقراطية في هذا المجتمع لأن تكون أكثر من ميكانيزم لتجميع التفضيلات. ولكن بما أن وجود مجتمع غير تعددي هو من المستحيلات الواقعية، فان المطالبة بالمزاوجة بين الديمقراطية والعدالة تصبح ذات أهمية قصوى.
اذا كانت التعددية هي في أساس الربط بين الديمقراطية الاجرائية والعدالة، فما هو الأساس للديمقراطية الاجرائية؟ انه ، باختصار، يكمن في عدم جواز خضوع البشر لسلطة أحد بدون رضاهم. فلا أحد هو من الذكاء والحكمة والطيبة بمكان بحيث يجوز أن يعطى الحق في أن يحكم الآخرين بدون رضاهم. ان الأهمية الايجابية التي يمكن اسنادها الى الفكرة الأخيرة هي أن كل الذين ينتمون الى نفس المتحد السياسي ويتأثرون، لهذا السبب، بمؤسساته السياسية من حقهم أن يشاركوا في تشكيل هذه المؤسسات وادارتها، بغض النظر عن المنظور أو المصلحة التي يمثلها كل منهم. فالقيم والسياسات التي يفترض أن تنتج عن عمل هذه المؤسسات لا تعني فئة من فئات المجتمع دون سواها، بل انها تعني جميع الفئات والأفراد في المجتمع. فهي، أصلا ً، ما يفترض أن تنظم حوله حياتهم الاجتماعية المشتركة. اذا ً، هذا يعطي لكل فرد أو فئة الحق في المشاركة في تقرير هذه القيم والسياسات. وهكذا يتضح أن جوهر المثال الديمقراطي يتمثل بفكرة كون المشاركة ينبغي أن تكون متاحة للجميع بدون استثناء.
من الافتراضات الأساسية المسبقة للالتزام بالمثال الديمقراطي الاعتقاد بقدرة العقل الجمعي (=العقل العام) على ايجاد الحلول للمشكلات التي تواجهه. فالبشر، عن طريق تعاونهم في استخدام مواهبهم وقواهم العقلية، قادرون على الحصول تدريجيا ً على المعرفة والحكمة الضروريتين لتوجيه جهودهم الجماعية في اتجاه ما يخدم مصالحهم المشتركة.
بامكاننا الآن أن نحدد، في ضوء ما سبق، الشروط اللازمة لاقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة. سألخص هذه الشروط في خمسة. أولا ً، الارادة الجمعية الواحدة هي التي ينبغي أن تكون المصدر الأخير للسلطة السياسية، ولا حق لأي فرد أو جماعة بالاستئثار بهذه السلطة. ثانيا ً، ينبغي أن تكون نفس الفرص متاحة للجميع للمشاركة في الحياة السياسية، مما يستدعي حياد الدولة ازاء المصالح المشروعة المتنافسة، وكذلك ازاء العقائد الشاملة المعقولة والمنظورات القيمية المتعارضة. ثالثا ً، ينبغي اعطاء كل مواطن الحق في ممارسة الحرية على أوسع نطاق يسمح به اعطاء حرية مماثلة للجميع. رابعا ً، لا يجوز تجريد أي عضو من أعضاء الدولة من حقوق المواطنة على نحو تعسفي، أي، مثلا ً، على أساس ديني أو اثني. خامسا ً، ينبغي تأمين اطار تعاوني تتوافر ضمنه الشروط القمينة بحصول تفاعل اجتماعي حواري بين كل ممثلي المصالح المشروعة والمنظورات القيمية المتنوعة، وكذلك كل ممثلي العقائد الشاملة المتعددة، بحيث تتاح الفرصة لكل صوت لأن يسمح ويتقيد جميع الفرقاء بمبدأ الاحترام المتبادل.
لنتناول الآن السؤال الذي تتمحور حوله هذه الدراسة، أي السؤال: لماذا هي العلمانية شرط ضروري لاقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة؟ هذا السؤال، في ضوء ما سبق، يتحول الى السؤال: لماذا غياب العلمانية يعني غياب مؤسسات تتوافر فيها الشروط الخمسة المذكورة أعلاه؟
حتى نعالج هذا السؤال على نحو مناسب، من المستحسن أن نحاول، أولاً، تحديد النتائج المترتبة على الموقف اللاعلماني، أي الموقف الذي يطالب باقامة الدولة على الدين. أول ما ينبغي أن نلاحظه في هذا الموقف هو أنه يقوم على الاعتقاد بأن للدين أغراضا ً دنيوية تتجاوز تهذيب النفس بالأخلاق الحسنة وما شاكل ذلك. في فكر الاسلاميين بالذات، الاسلام دين ودولة، بل ان الاسلام عقيدة شاملة كل الشؤون الاخروية والدنيوية على حد سواء. ان هذا يدفع بهم الى حد الاعتقاد أن شمولية الاسلام هي في صلب ماهيته باعتبار دينا – أي في صلب ماهيته العقدية. وهذا ما يفسر لماذا نراهم لا يتورعون عن اعتبار العلمانية مروقا ً من الدين وصنو الالحاد. فالاعتقاد بالله، من منظورهم، يتضمن منطقيا واجبات تشمل كل مناحي الحياة الدنيا، السياسية منها وغير السياسية. ولذلك فان علمنة السياسة، التي تعني، على الأقل، الفصل بين الواجبات الدينية والواجبات السياسية، هي، بحكم "منطق" تفكيرهم، بمثابة نقض للاعتقاد بالله.
لا يمكن أن يختلف الأمر كثيرا ً بالنسبة لأي موقف مناف للعلمانية، بغض النظر عما اذا كان هذا الموقف نابعا ً من منظور اسلامي أم من منظور مسيحي أو يهودي أصولي. فان أي موقف كهذا لا بد أن ينطلق من الافتراض أن العقيدة الدينية، التي اتفق أن صاحب هذا الموقف يدين بها، تفرض عليه رفض ما يدعوه روبرت عودة "The Principal of Secular Rationale" مبدأ المسوغ العلماني). ينص هذا المبدأ على أن من واجبات الوهلة الأولى Prima facie واجب عدم تأييد أو دعم أي قانون أو أي سياسة عامة تقيد أفعال البشر على نحو أو آخر، الا اذا كان ثمة أسباب علمانية لهذا التأييد أو الدعم. والمقصود بالأسباب العلمانية تلك الأسباب التي لا يفترض التسليم بها الاعتقاد بالله. ولذلك فان رفض هذا المبدأ هو بمثابة تأكيد على عدم الاعتراف بكفاية أو حتى أهمية الأسباب العلمانية. وهذا بدوره يقوم على تأويل رفض هذا المبدأ لعقيدته الدينية على نحو يجعلها تفرض عليه عدم الاكتفاء بالأسباب العلمانية أو حتى ايلاءها أهمية تذكر. من هنا يتضح كيف يتحول الالزام السياسي بسحر ساحر الى الزام ديني.
يبلغ هذا منتهى الوضوح في الحركات الممثلة للاسلام السياسي، حيث نجد أن من السمات البارزة المشتركة بينها الاعتقاد بأن الاسلام يرتبط مفهوميا ً بالسياسة. اتخاذ الاسلام بعدا ً سياسيا ً، اذا ً، ليس حاصل ظروف تاريخية أملت اتجاهه هذا الاتجاه، بل انه شيء في صلب عقيدته باعتباره دينا ً. وهذا يترجم، من منظورهم، الى واجب ديني يفرض تنظيم المسلمين في حزب سياسي، من أغراضه الأساسية اقامة دولة اسلامية، أي دولة منظمة حول المبادىء والقيم الاسلامية. فالاسلام، باعتباره دينا ً، لا يكتمل، حسب هذه النظرة، الا اذا تحقق الغرض الأخير. من الواضح هنا أن تسييس الاسلاميين للاسلام يختلف بصورة جوهرية عن تسييس دعاة لاهوت التحرير في أميركا اللاتينية للمسيحية، لأن الأخيرين لم يروا الى السياسة بوصفها ترتبط جوهريا ً بالمسيحية. وكذلك فان تسييسهم للاسلام، وان تشابه نوعا ً ما مع تسييس اليمين الديني في الولايات المتحدة للمسيحية، الا أنه يتجاوز الأخير، نظرا لرؤيته الاسلام، من جهة، على أنه نظام شامل كل مناحي الحياة، ولرؤيتهم السياسة، من جهة ثانية، على أنها وسيلة لتحقيق هذا النظام الشامل، عملا ً بالأمر الالهي. وهذا يفرض تبنيهم الموقف الكلياني في السياسة، حيث تعني أسلمة السياسة أسلمة كل مناحي الحياة فحتى المعرفة والعلوم لا تستثنى من الأسلمة. ومن يذهب الى هذا الحد في عملية الأسلمة، فانه لا يمكن أن يرضى بأقل من أسلمه السياسة أسلمة كل مناحي الحياة فحتى المعرفة والعلوم لا تستثنى من الأسلمة. ومن يذهب الى هذا الحد في عملية الأسلمة، فانه لا يمكن أن يرضى بأقل من أسلمة تامة للقانون والاقتصاد والتربية والفن، والقيم... الخ. وأسلمة شاملة كهذه تتضمن أن الواجبات الدينية للمسلم تشمل واجب اخضاع كل مناحي الحياة لمعايير اسلامية، بل وتجعل الواجب الأخير متمما ً للواجبات الأساسية للمسلم، واجب العبادة والصوم والحج والزكاة. هنا نجد بذور نظام لكلي. فهذه النظرة الى الاسلام، على افتراض نجاح الآخذين بها في تأمين استلامهم مقاليد السلطة السياسية في بلدهم، لا بد أن تترجم الى ترتيبات سياسية لا تسمح لأي منظور علماني أو غير اسلامي أن ينافس المنظور الاسلامي في أي مجال من مجالات الحياة. فكل هذه المنظورات الأخرى، وان كانت تتعلق بجوانب للثقافة والحياة الاجتماعية، لا تعتبر بحق مشمولة بالدين، بوصفه دينا ً، الا أنها ستجد نفسها، في ظل دولة دينية، معرضة باستمرار لشتى الضغوط للاندماج في المنظور الديني، بحسب فهم الاسلاميين له، أو، على الأقل، لعدم الانحراف عنه. التنوع الثقافي، بكل ما ينطوي عليه من تعددية قيمية، وكذلك الحريات الشخصية، لا بد أن تكون الضحية في وضع كهذا.
يتضح هذا أكثر عندما نأخذ في الاعتبار المبرر، من وجهة نظر الاسلاميين، لاعتبارهم اقامة دولة اسلامية واجبا ً دينيا ً. هذا المبرر هو أن "الحاكمية هي لله". لا شك طبعا ً أن ثمة تأويلا ً لاسناد الحاكمية لله لا يمكن الاعتراض عليه، الا وهو التأويل اللاهوتي (الكلامي) المتعارف عليه. الله، بحسب هذا التأويل، هو الخالق لكل شيء والضامن لاستمرار كل شيء في الوجود، مما يعني أنه أيضا ً الحاكم المطلق والنهائي للكون. ان اسناد الحاكمية لله، بهذا المعنى، يقوم على حقيقة تحليلية لا يمارى فيها، أي حتى الملحد أو اللا أدري يسلم بها، ما دامت تجرد من أي مدلول وجودي، أي حقيقة أن الله بالتعريف هو الخالق لكل شيء والضامن لاستمرار كل شيء في الوجود، مما يعني أنه أيضا ً الحاكم المطلق والنهائي للكون. ان اسناد الحاكمية لله، بهذا المعنى، يقوم على حقيقة تحليلية لا يمارى فيها، أي حتى الملحد أو اللا أدري يسلم بها، ما دامت تجرد من أي مدلول وجودي، أي حقيقة أن الله بالتعريف هو الخالق لكل شيء والضامن لاستمرار كل شيء في الوجود. فما دمنا هنا معنيين بالتصور السائد للألوهية في التقليد الابراهيمي، فان مفهوم الله يتضمن محمول كونه الخالق والضامن للوجود. ثمة تصورات أخرى طبعا لا تقود الى نفس النتيجة بخصوص كيف ينبغي أن نفهم سيادة الله على الكون. خذ، مثلا ً، تصور ربوبي كفولتير. ما يتضمنه هذا التصور هو أن الله خلق الكون ولم يعد له أي شأن فيه بعد خلقه له. ولكن ما يعنيني هنا هو التصور التقليدي، الذي يتضمن أن الله يحكم العالم، بمعنى أن القوانين الطبيعية وكل ما في الكون يخضع لارادته المطلقة، ويجد ضمانه في القدرة الالهية الكلية، وأن الله وحده يمتلك القدرة على تعليق هذه القوانين أو حتى الغائها، اذا شاء ذلك.
لا يقف الاسلاميون عند الحد الأخير في فهمهم للحاكمية الالهية، بل انهم يخرجون مفهوم الحاكمية من سياقه اللاهوتي (الكلامي) الخالص ليزودوه بدلالة سياسية – اجتماعية. أنا شخصيا ً أرفض هذا الفهم للحاكمية الالهية، وقد بينت في كتابات أخرى عديدة انه فهم يقوم على اغلوطة كبرى هي أغلوطة تحويل الجائز الى واجب. انه، بمعنى آخر، يقوم على النظر الى العلاقة التاريخية بين الاسلام والسياسة، التي هي، في أفضل حال، علاقة واقعية، وبالتالي جائزة على أنها علاقة واجبة منطقيا ً بدون هذا الخلط بين الجائز والواجب. لا يمكن فهم الحاكمية الالهية الا بمعناها اللاهوتي الخالص، أي على أنها لا تتضمن أكثر من كون الله هو الخالق لكل شيء والضامن المطلق للوجود.
ولكن لا يعنيني هنا ما هو التأويل الصحيح لمفهوم الحاكمية الالهية، وبالتالي، لعلاقة دين سماوي، كالاسلام، بالشؤون الدنيوية. ما يعنيني بالأحرى هو تأويل المسيسين للدين، مسلميهم ومسيحييهم ويهودييهم، على حد سواء، لهذا المفهوم والنتائج المترتبة على هذا التأويل. وما يتضح مما سبق هو أن الحاكمية الالهية، بحسب هذا التأويل، تمتد الى المجال السياسي – الاجتماعي. وهذا يعني أن التنظيم السياسي للمجتمع ينبغي أن يخضع للقانون الالهي. نجد في هذا التأويل بذور تكون الشروط المثالية لاعطاء السلطة السياسية، التي تعمل بمقتضى هذا التأويل، الحرية لاخضاع كل مجالات الحياة لتشريعاتها. كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، ما دام الله، بحسب هذا التأويل، هو الحاكم المطلق والنهائي لكل شيء، أي لا شيء الا ويخضع لسلطته، حيث تفهم السلطة هنا بمعناها الاجتماعي – السياسي؟ لا شك أن تأويلاً كهذا يحول شعار "الحاكمية لله" الى وصفة ممتازة للتوتاليتارية بأروع صورها. ف "منطق" تأويل الحاكمية على النحو المعني هنا هو "منطق" اختزالي وشمولي في اختزاليته. فهو، من جهة، يرد الواجبات الى واجب واحد أساسي، واجب طاعة الله، وهنا تكمن اختزاليته. وهو، من جهة ثانية، لا يخرج من دائرة هذه الواجبات حتى ما يتعلق بالمجال الخاص، مجال الحريات الشخصية، وهنا تكمن شموليته. ولذلك فان اتخاذ السلطة الالهية مدلولا ً سياسيا ً – اجتماعيا ً يعني، في هذه الحالة، اخضاع الأفعال الانسانية لقانون الهي كلي الشمول. وهذا لا يعني فقط تحويل الالزام السياسي الى الزام ديني، بل، والأسوأ من ذلك. اخضاع كل مجالات الحياة للسلطة السياسية، التي هي، عمليا ً، سلطة بشر، ليس الا. فسلطة الله، على افتراض أنها تمتد الى المجال السياسي – الاجتماعي، لا يعقل أن تمارس على نحو مباشر، على افتراض رفض موقف الربوبي من علاقة الله بخلقه. وهذا لا يمكن أن يتضمن سوى أن الذين يدعون الكلام باسم الله أو أنهم المؤهلون للحكم باسم الله، لو أتيحت لهم الفرصة لأن يحكموا، سيقومون، في غياب أي معرقلات لمساعيهم، بتنفيذ منهاجهم القاضي باعطاء الشرع الالهي، بكل شموليته المزعومة، طابعا ً رسميا ً من خلال التشريع الانساني. ولكن ما الذي يمكن أن يعنيه هذا عمليا ً سوى تلاشي المجال الخاص في المجال العام، أي اقامة نظام كلي؟
من الواضح، في ضوء ما سبق، أنه لا شرط من الشروط الخمسة الضرورية لبناء مؤسسات ديمقراطية عادلة يمكن أن يتوافر في دولة دينية تقوم على التأويل السابق للحاكمية الالهية. لنبدأ بالشرط الأول. يتضمن هذا الشرط، كما رأينا، أن تكون الارادة الشعبية وحدها للسلطة، وبالتالي، عدم استئثار أي فرد أو جماعة بالسلطة. ولكن اذا كانت الحاكمية لله وحده، وكانت تفهم على أنها ذات مضمون سياسي – اجتماعي، اذن ما دامت الحاكمية في المجال العام لا تمارس الا من خلال بشر، فان ما يتبع من هذا بالضرورة هو أن الجماعة الأيديولوجية التي ستحكم باسم الله لن يكون لها غرض أهم من الاستئثار بالسلطة. كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، ما دامت الحاكمية، التي هي لله وحده، تؤول اليهم، عمليا ً؟ الاسلاميون أنفسهم لا يكلون من التصريح، بدون أي تردد، أنهم حزب الله وأن الأحزاب المنافسة هي أحزاب الطاغوت. حتى الذين يزعم أنهم معتدلون (راشد الغنوشي، مثلا ً) ليسوا على استعداد للتسامح سياسيا ً مع منافيسهم، الا اذا لم يختلف الأخيرون معهم سوى بخصوص الوسائل وليس الغايات. اذا ً، ينبغي أن تؤول السلطة السياسية الى الذين لا هدف لهم سوى أن يحكموا باسم الله، وأن تبقى السلطة بأيديهم، ما داموا لا ينحرفون عن هذا الهدف. أما الباقون، حتى وان لم يضطهدوا، فانهم حتما ً سيهمشون تهميشا ً تاما ً. السلطة السياسية هي من حق السابقين وحدهم، ليس لأنه يقوم على الارادة العامة، بل لأنهم المؤهلون للحكم باسم الله.
لا ينفع الاعتراض هنا على تحليلنا السابق، على أساس أن الله لا يحكم بصورة مباشرة، ولا هو من يمنح الحاكم سلطته، مما يعني أن الفرصة متاحة لاقامة نظام سياسي يعطي للارادة العامة، من حيث المبدأ، دورا ً بارزا ً، وحتى حاسما ً، في تقرير من يحكم. أقول لا ينفع الاعتراض على هذا الأساس، اذ كائنا ً ما كان النظام السياسي القائم، وبغض النظر الى أي حد يتمثل هذا النظام بالأنظمة الديمقراطية المعروفة، من الناحية الاجرائية، فان واقع الأمر هو أن الدولة الاسلامية المتصورة من قبل الاسلاميين ستتخذ، دستورياً وتنظيميا ً، الصورة التي تضمن حصر السلطة السياسية فيهم. ان هذا نابع بالضرورة من "منطق" تفكيرهم. وما نجده في ايران ما هو الا صورة صارخة له – هذا "المنطق" الذي يرتد الى ثلاثة مكونات أساسية. المكون الأول يتعلق باعتقادهم أن واجب اقامة دولة اسلامية هو واجب ديني. والثاني يتعلق باعتقادهم أن الدولة الاسلامية المرجوة ينبغي أن تستوحي تشريعاتها من القانون الالهي. والثالث يتعلق باعتقادهم أنهم وحدهم المؤهلون لاعطاء التأويل المناسب للقانون الالهي. والثالث يتعلق باعتقادهم أنهم وحدهم المؤهلون لاعطاء التأويل المناسب للقانون الالهي وفض مكنونه السياسي – الاجتماعي. انطلاقا ً من هذه الاعتقادات الثلاثة، كيف يمكن للذين يسلمون بعناد أخرق بها، وكأنها مسلمات واضحة بذاتها، كيف يمكن لهم، في حين استلامهم مقاليد السلطة السياسية، ألا يجعلوا الاستئثار بها غرضهم الأساسي؟ عدم محاولتهم الاستئثار بها سيكون، من جهة نظرهم، اخلالاً بواجبهم الديني، أي عدم امتثال لأمر الهي. وواضح أنه لا يمكن أن يوجد، من وجهة نظرهم، أي دافع لعمل، أو للاستنكا ف عن عمل شيء ما أقوى من كون هذا الشيء هو، في اعتقادهم، ما يأمر الله بعمله أو الاستنكاف عن عمله. من ناقل القول، اذن، أنهم لو تسلموا مقاليد السلطة، فان "منطق" تفكيرهم سيدفع بهم بالضرورة نحو عمل كل ما يلزم لضمان حصرها في أيديهم بصورة دائمة. وأي دور فعلي يبقى للارادة الجمعية في هذه الحالة؟
لننتقل الآن الى الشرط الثاني لاقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة، أي شرط الحياد. المبرر الأساسي لاقامة مؤسسات كهذه، كما بينا، هو أنه لا يجوز أن يخضع البشر لسلطة أحد بدون رضاهم. حق تقرير السياسات والقيم التي يفترض أن ينظم حولها متحدهم الاجتماعي هو حق لكل عضو من أعضاء هذا المتحد، وليس لفئة مختارة منهم، أو حتى لأكثريتهم. وامتلاكهم هذا الحق، جميعا ً مشتق من امتلاكهم له، استغراقيا. اذن، هو، في أساسه، حق لكل شخص في أن يشارك في الحياة السياسية على قدم المساواة مع كل شخص آخر، مثلما هو، في عالم مخترق بالتعددية، حق لكل منظور في أن يشغل حيزا ً في الفضاء العام.
لا نحتاج الى كبير عناء هنا لنبين أن الدولة الاسلامية المزمع اقامتها لا يمكن، بحكم طبيعتها، أن تكون محايدة ازاء المنظورات المتعددة وأن تعمل، بالتالي، على ضمان المساواة في فرص العمل السياسي لجميع الأفراد والفئات، وتوفير الشروط لكل صوت لأن يسمع أن اقحام الدين في السياسة على طريقة الاسلاميين أو اليمين الديني في الولايات المتحدة، مثلا ً، لا بد أن يقود في اتجاه عدم الاعتراف بمشروعية التعددية. وهذا يعود الى وجود نزعتين في الدين، أي دين، النزعة الاختزالية والنزعة نحو اسباغ طابع مطلق على العقيدة الدينية. لا خطر من هاتين النزعتين على التعددية، ما دام لا يتجاوز فهم العقيدة الدينية مضمونها الميتافيزيقي لتزويدها بمضمون سياسي – اجتماعي. ولكن لا بد أن تختلف الصورة كليا ً، في حال تزويد العقيدة الدينية بمضمون سياسي – اجتماعي، اذ لا بد أن يقود هذا، بسبب هاتين النزعتين، الى تكون شروط معادية للتعددية أو الاختلاف، بأي معنى من معانيه. فالنزعة الاختزالية، مثلا ً، في حال تجسدها في مواقف معينة من القضايا العامة، تتحول الى نزعة نحو النظر الى التعارض في القيم أو المصالح أو المنظورات على أنه يختزل في تعارض واحد أساسي: تعارض بين الخير والشر (بين حزب الله الطاغوت). والمعادل لهذا في المعترك السياسي هو تحول الصراع الى قتال لا ليونة ولا استعداد للمساومة فيه، بدل أن يكون شيئا ً يمكن تدبره سياسيا ً على نحو يستهدف التقريب بين وجهات النظر المتعارضة والمصالح المتضاربة.
والنزعة الثانية هي نزعة الدين نحو جعل معاييره نهائية ومطلقة. وفي حال تجسد هذه النزعة في أيديولوجيا سياسية – اجتماعية، فان ما يترتب عليها، في أفضل حال، هو النظر الى ما يتعارض مع المضمون السياسي – الاجتماعي المزعوم للعقيدة الدينية على أنه انحراف خطير عن الحق والحقيقة، دون أن نذكر أن النظر اليه كذلك، من هذا المنظور، يسبغ عليه طابع الخطيئة المميتة. من هنا يتضح أن ترجمة هذه النزعة الى موقف محدد من القضايا السياسية والاجتماعية هو بمثابة ترجمتها الى موقف ينظر الى كل المواقف المخالفة له، مع المصالح أو القيم التي تمثلها، على أنها مجردة من أي مشروعية ولا تستحق أي اعتبار. ونزعة كهذه لا يمكن أن تتعايش مع الاختلاف والتعدد أو أن ينتج عنها نظام سياسي محايد.
قد يعترض بعضهم على أساس أن الدولة الدينية المرجوة لا يمكن أن تكون غير عادلة، ما دامت تتخذ من القانون الالهي أساسا ً لها. فالقانون الالهي عادل بالتعريف. ولذلك فالمؤسسات السياسية التي ستعمل بوحيه لا بد أن تتوافر فيها شروط العدالة أكثر من أي مؤسسات من نوعها لا تعمل بوحيه. ردي على هذا الاعتراض بسيط: انه ليس أكثر من مجرد هراء الادعاء أن القانون الالهي هو الذي سيوجه عمل هذه المؤسسات، ما يصح قوله، بالأحرى، هو أن ما سيشكل الموجه لها هو ما يعتقد الاسلاميون أنه القانون الالهي وما يزعمون أنه المضمون السياسي – الاجتماعي له. فالقانون الالهي المزعوم يتحول الى أيديولوجية سياسية – اجتماعية عاكسة لوجهة النظر الخاصة بالجماعة الاسلامية التي ستؤول اليها مقاليد السلطة، ومعبرة عن المصالح الخاصة بها. ونتائج هذا واضحة. فما دامت الجماعة المعنية لا يمكن أن تعترف أنه بمقدور أي جماعة سواها لا تشاركها منظورها أن تصل الى المواقف الصحيحة من القضايا العامة، فانها ستعمل على استبعاد أي دور سياسي لأي جماعة ذات منظور منافس. لا يمكننا، في هذه الحالة، أن نتوقف أن تتاح لغير المسلم أو اللاأدري، أو حتى للمسلم الليبرالي أو العلماني، أي فرصة حقيقية للمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الذين يتماهى منظورهم مع المنظور الاسلامي المسيطر.
من الاعتراضات على موقفي الاعتراض على أساس أن المؤسسات الديمقراطية تعمل وفق قاعدة الأغلبية، واذا كانت أغلبية السكان في بلد ما من المسلمين واختارت، ديمقراطيا ً، أن يقوم الحكم فيها على أساس ديني، فلا يمكن أن يكون في هذا أي انحراف عن مستلزمات اقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة.
ان ردي على هذا الاعتراض هو أن الطريقة التي قد تؤدي الى اقامة حكم اسلامي، في هذه الحالة، وان كانت ديمقراطية، من الوجهة الاجرائية، الا أنها، من حيث الجوهر، تمثل كل ما هو مناف لاقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة. ما نلاحظه، بدئيا ً، هو أن مجرد مطالبة جماعة اتفق أنها أكثرية عددية في مجتمع ما مجرد مطالبتها بأن تصبح أغلبية سياسية وأن يكون هناك ضمان دستوري لاستمرارها كذلك منافية لروح الديمقراطية وللواجبات المدنية النابعة منها. ان هذا يصدق على هذه المطالبة، بغض النظر عما اذا كانت الجماعة المطالبة بذلك تشكل أكثرية دينية أو أكثرية اثنية أو ثقافية.
لتوضيح هذه المسألة أكثر، من الضروري التمييز، في البداية، بين المبادىء المكونة للممارسة الديمقراطية والمبادىء التي ينبغي أن توجه اختبارنا للأساسيات الدستورية. مبدأ حكم الأغلبية هو من النوع السابق. لا مهرب من تبني هذا المبدأ اذ لا يمكن عمليا ً وواقعيا ً تحقيق الاجماع حول القضايا السياسية. أن نطالب بالاجماع في المجال السياسي هو بمثابة مطالبتنا بشل الارادة الجمعية. ولكن الأمر يختلف بالنسبة لاختيارالأساسيات الدستورية. لا يمكن قبول اقامة هذا الاختيار الا على أساس الاجماع. أن نطالب هنا بأقل من الوصول الى اجماع حول هذه الأساسيات، أو بأقل من تحقيق "اجماع متشابك" بحسب تعبير جون رولز، هو أن نفسح المجال واسعا ً أمام أكثرية دينية أو عرقية لأن تؤمن لنفسها التحول الى أغلبية سياسية دائمة. ولكن أن تتماهى الأكثرية الدينية أو العرقية مع الأغلبية السياسية على أساس دستوري هو أن تصبح بالضرورة غير ديمقراطية وغير عادلة، لأن حكمها، في هذه الحالة، لن يقوم على قاعدة الأغلبية، بالمعنى الاجرائي المتعارف عليه، اذ انه لا بد أن يتجه نحو تحويل هذه القاعدة الى مجرد ستار لطغيان الأكثرية. ولذلك فان المبادىء التي ينبغي أن تشكل الملاذ الأخير لأي مجتمع ديمقراطي – المبادىء الدستورية – لا يمكن أن تضمن اقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة، الا اذا كان ثمة اجماع متشابك حولها. الاجماع المتشابك فرض واجب على مستوى اختيار الأساسيات الدستورية لضمان أن تكون المبادىء المتفق حولها منصفة للجميع ولا تقود، على مستوى الممارسة، الى طغيان الأكثرية.
لنفترض أن المبادىء الدستورية في مجتمع ما تعكس فقط منظور الأكثرية الدينية في هذا المجتمع. من الأمور التي تترتب على ذلك هو أن هذه المبادىء ستجسد تصور الخير الخاص بهذه الأكثرية والنابع من عقيدتها الشاملة، مثلما ستجسد تصور الخير الخاص بهذه الأكثرية والنابع من عقيدتها الشاملة، مثلما ستجسد المصالح الخاصة بها. ولذلك فان وضع هذه المبادىء موضع التنفيذ لا يمكن أن ينتج عنه سوى شيء واحد: فرض تصور خاص للخير على الجميع وتهميش، ان لم نقل اخراس، كل الأصوات الممثلة لتصورات أخرى للخير ولمصالح أخرى. لا متسع، في هذه الحالة، للتعددية من حيث هي تعددية قيم وتعددية مصالح.
زد الى ذلك أن دستورا ً هذا شأنه لا بد أن يستبعد الشروط الثلاثة الباقية لاقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة. الشرط الثالث. كما رأينا، هو اعطاء كل عضو من أعضاء الدولة الحق في ممارسة الحرية على أوسع نطاق يسمح به اعطاء حق مماثل للجميع. حرية الاعتقاد مركزية هنا، وهي تشتمل على حق الفرد في أن يعتنق في أي دين يشاء وفي أن يغير دينه أو يتبنى موقفا ً لا أدريا ً أو ملحدا ً. ولكن حرية كهذه لا يمكن تأمينها الا في دولة تلتزم الحياد، ليس فقط ازاء العقائد الدينية المتباينة بل وأيضا ً ازاء الدين. فلا يمكن لدولة دينية، أو لا تلتزم الحياد ازاء الدين، أن تناط بها مسؤولية تأمين حرية الاعتقاد الديني ونشر روح التسامح في المجتمع الى الحد الذي يتيح للأفراد أن يمارسوا حرية الضمير في غياب أي اكراهات خارجية. لا يمكن أن يتولد عن الدولة الدينية سوى ما هو معاد لروح التسامح. انها تخلق الشروط المثالية لتسهيل ممارسة الضغوط غير العادية على غير الذين يدينون بدين الدولة ليغيروا دينهم ويتبنوا دين الأكثرية وعلى الذين يدينون بدين الأكثرية ليستمروا في اعتقادهم. ان "منطق" الدولة الدينية هو على نحو لا يسمح بتكون الشروط القمينة بممارسة حرية الضمير. قد لا توجد قوانين تحد من هذه الحرية – وان كان هذا شبه مستحيل ولكن واقع الأمر هو أن غياب الحياد ازاء العقائد الدينية في هذه الدولة يشجع الأكثرية الدينية على عدم التسامح مع الذين لا يشاركونها اعتقادها الديني، بما في ذلك اللا أدريون والملحدون طبعا ً. ولا بد لغياب التسامح من أن يترجم الى ممارسة ضغوط مستمرة على الأخيرين ليدينوا بدين الدولة.
بالاضافة الى الضغوط الناتجة من عدم التسامح، توجد ضغوط أخرى ناتجة عن كون الدولة الدينية، مدعوة، بحكم طبيعتها، لاستبعاد من لا يدينون بدين الدولة من المراكز المهمة والحساسة. والأسوأ من هذا أن دولة كهذه لا بد أن تقوم بحرمان من يغيرون دينهم، ان اتفق أنه دين الأكثرية، وحرمان اللا أدريين والملحدين كذلك، من حقوقهم المدنية ومعاملتهم معاملة المجرمين. وهذا يتعارض مع الشرط الرابع من الشروط الخمسة الضرورية لاقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة، أي شرط عدم حرمان أي عضو من أعضاء الدولة من أي حق من حقوقه المدنية على أسس تعسفية. كل عضو من أعضاء الدولة، بغض النظر من اعتقاده الديني أو موقفه من الدين، يتأثر بسياسات وتشريعات هذه الدولة. وهذا وحده يعطيه الحق ليس فقط لأن يكون له دور في تقرير وادارة مؤسسات الدولة على قدم المساواة مع سواه بل، وأن يكون له أيضا ً نصيب عادل من الخيرات، والمنافع، والأعباء العامة. ليست اعتقادات الشخص، كائنة ما كانت، ذات أهمية بهذا الخصوص، ولكن فقط كون هذا الشخص يشارك في حياة متحد لا بد أن يتأثر، على نحو أو آخر، بالقرارات الجمعية لهذا المتحد. وهذا لا يعطيه فقط الحق في أن يشارك على قدم المساواة مع سواه في الحياة السياسية، التي يفترض أن تنتج عنها هذه القرارات، بل وأيضا ً الحق في أن يسعى الحصول على أي منصب أو وظيفة، حتى وان كانت تتعلق بصورة مباشرة وأساسية بصنع القرارات المتعلقة بالحياة العامة.
في الدولة الدينية، دين الشخص أو موقفه من الدين هو ذو أهمية كبرى في تقرير مدى امتلاكه لحقوق المواطنة وما هو نصيبه من الخيرات، والمنافع، والأعباء العامة. في الدولة الاسلامية المنشودة من قبل الاسلاميين، مثلا ً، مواطنية غير المسلمين لن تعتبر مكتملة بدون تبنيهم الاسلام دينا ً. أما اللا أدريون والملاحدة، من بين المسلمين بالولادة، فان مصيرهم سيكون أسوأ بكثير من مصير غير المسلمين، اذ انهم سيعاملون معاملة المجرمين. فحتى اسلامي "معتدل" نسبيا ً كراشد الغنوشي لا يتورع عن تأييد تجريم المرتدين، وما يميزه عن غير الاسلاميين هو أنه يعتبر جريمتهم جريمة سياسية، ليس الا. ولكن من الواضح أن تجريم المرتد، بغض النظر عن كيفية تصنيف "جريمة" الارتداد، هو بمثابة تجريد لمواطنين من بعض حقوقهم بسبب اعتقاداتهم.
من الجدير بالملاحظة هنا أن العلمانيين، حتى وان لم يتخلوا عن اسلامهم، سيكون لهم نفس مصير المرتدين في الدولة الاسلامية المنشودة. فكما رأينا في البداية، فان العقيدة الاسلامية، من منظور الاسلاميين، تتضمن اعتبار اقامة دولة اسلامية واجبا ً دينيا ً، مما يستدعي النظر الى العلمانية على أنها مروق من الدين الحنيف، وبالتالي، شكل من أشكال الارتداد. ولكن حتى ولو تجنب العلمانيون بأعجوبة مصير المرتدين في الدولة الاسلامية المنشودة، فانهم حتما ً لن يوضعوا سوى في خانة أعداء الدولة، مما سيزود القيمين على مقدرات الدولة بكل ما يحتاجون اليه لتجريدهم من الكثير من حقوقهم الأساسية بسبب اعتقادهم العلماني.
لننصرف الآن الى تناول الأسباب لتعارض الدولة الدينية مع الشرط الخامس والأخير لاقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة. يتعلق هذا الشرط، كما رأينا، بتأمين اطار تعاوني قمين بحصول تفاعل اجتماعي حواري بين ممثلي مختلف المنظورات والمصالح الجمعية المشروعة والعقائد الشاملة، بحيث يتقيد الجميع بمبدأ الاحترام المتبادل في المجالات التي ليس لأي فريق أي امتياز معرفي بها. فالمبرر الأساسي للمؤسسات الديمقراطية، كما بينا، هو الاعتقاد بضرورة اعطاء جميع الأفراد والفئات نفس الفرص للمشاركة في تقرير القيم والسياسات والمعايير التي يفترض أن تنظم حولها حياتهم المشتركة. ولكن لا يمكن فصل الاعتقاد الأخير عن الاعتقاد بقدرة "العقل العام" على ايجاد الحلول لمشكلات المجتمع المشتركة. ولكن العقل العام هو العقل الجمعي، ولا يمكن، بالتالي، أن يعمل بصورة فعالة الا ضمن اطار تعاوني، حيث تكون سيرورة التفاعل الحواري المجسدة لعمل العقل العام كلية الشمول وتجد الضمان لاستمراريتها في التقيد بمبدأ الاحترام المتبادل.
لا يمكن لدولة دينية سوى أن تستبعد من سيرورة التفاعل الاجتماعي الحواري كل من لا يدينون بدين الدولة، وكذلك كل العلمانيين، حتى وان كانوا يدينون بدين الدولة. فمن غير المعقول أن نتوقع مشاركة الأخيرين مشاركة فعالة في تقرير السياسات والقيم والمعايير التي يفترض أن ينظم حولها متحدهم، والتي سيكون لنتائجها أثر على مصالحهم. لا مفر من استبعاد الأخيرين من المشاركة الفعلية – لا الاسمية – في الحياة العامة، ما دام ما تعنيه هذه المشاركة في الدولة الدينية هو الوصول الى اتفاق حول أي السياسات والتشريعات والقيم المقترحة تنسجم على النحو الأفضل مع التعاليم الدينية، كون المشاركة تعني أن هذا يتضمن بالضرورة أن الوحيدين الذين لهم الحق في أن يقوموا بدور فعال في المجال العام هم الذين ينتمون الى الجماعة الدينية الحاكمة ويؤيدون أيديولوجيتها السياسية – الاجتماعية اللاعلمانية. كل من عداهم لا بد أن يحظر عليه بصورة آلية القيام بدور كهذا. ان وضعهم، في هذه الحالة، هو وضع المتفرج على ما يجري على المسرح العام.
يتضح هذا أكثر بالنظر لكون الدولة الدينية، أو حتى المطالبة باقامتها، تشكل خرقا ً فاضحا ً لمبدأ الاحترام المتبادل. يستلزم هذا المبدأ، كما رأينا، أن تقترن المساواة في المشاركة مع المساواة المعرفية. وهذا يعنى أنه عندما يتعلق الأمر بتعارض عقائد ميتافيزيقية شاملة، أو بتعارض منظوراتها القيمية المختلفة، فان ما هو مطلوب، كحد أدنى، لضمان استقرار المتحد الاجتماعي هو أكثر من تحقيق تسوية موقتة بينها. ما هو مطلوب بالأحرى هو تقيدها بمبدأ الاحترام المتبادل، الذي يوجب، كما بينا، أن يحترم مؤيدو كل عقيدة أو تصور شامل للخير الحق المعرفي لكل من يؤيدون عقيدة أخرى أو تصورا ً آخر في أن يختاروا الطريق التي يرونها مناسبة الى"الحق" و"الحقيقة". الاحترام المتبادل، في هذا السياق، يعني المساواة المعرفية. في غياب المساواة المعرفية في المجال العام، تتحول سيرورة التفاعل الاجتماعي الحواري حول القضايا العامة الى ساحة عراك، حيث كل فريق يحاول فرض عقيدته وتصوره الشامل للخير على المجتمع ككل. وهذا، في الواقع، يشكل بداية عملية استبعادية تنتهي الى الغاء المساواة في المشاركة، الا اذا لم تتوافر لأي فريق الفرصة لفرض سلطته المعرفية على سائر الفرقاء، مما قد ينتهي بهم الى تحقيق تسوية موقتة. ولكن في حال نجاح فرض فريق سلطته المعرفية، فان نجاحه في ذلك هو بمثابة نجاح في الحظر على أي فريق آخر القيام بأي دور يذكر في الحياة العامة. ان غياب المساواة المعرفية هو غياب للمساواة في المشاركة وبداية انهيار سيرورة التفاعل الاجتماعي الحواري في المجتمع المدني. ليس انهيار سيرورة الحوار محترما ً فقط في حال قيام دولة دينية بل وأيضا ً في حال تسييس الدين على طريقة اليمين الديني في الولايات المتحدة وطريقة الاسلاميين عندنا. ثمة فرق طبعا ً بين ما تؤول اليه هذه السيرورة في ظل دولة دينية وما تؤول اليه نتيجة تسييس الدين، سعيا ً وراء اقامة دولة دينية. ففي الحالة السابقة، نجد أن الجماعة التي تحكم باسم الدين يعود اليها وحدها حق تقرير شروط المشاركة في الجدل الذي يمكن أن يجري حول القضايا العامة، نظرا ً لكون سلطتها المعرفية هي السلطة النافذة. ولذلك حتى يحق لأي فريق آخر أن يشارك في هذا الجدل، فان عليه أن يتقيد بهذه الشروط وأن يتخلى، بالتالي، عن سلطته المعرفية للفريق الحاكم، والا فسيستبعد من المشاركة في ما يجري على الساحة العامة.
أما في الحالة الأخرى، حيث يجري تسييس الدين طلبا ً لاقامة دولة دينية، فان الفريق اللاعلماني ليس في وضع بعد يسمح له بان يقرر شروط المشاركة في العقل العام. ولكن، مع ذلك، فان مجرد تسييس الدين للغرض المذكور يشكل خرقا ً فاضحا ً لمبدأ الاحترام المتبادل ولمبدأ المساواة المعرفية معه. يعود سبب ذلك الى أن المطالبة بتأسيس دولة دينية هي مطالبة باقامة مؤسسات قانونية واجتماعية حيث يكون للسلطة المعرفية للفريق المطالب بها القول الفصل. وهذا بمثابة دعوة لكل فريق منافس للتخلي عن سلطته المعرفية للفريق اللاعلماني. لا يوجد اعتراف في هذه الدعوة بأنه لا وجود لألغاء ثم للحسم في المسائل ذات الطبيعة الدينية أو الميتافيزيقية، وان الطريقة الوحيدة المنصفة لأصحاب العقائد الشاملة المختلفة لتنظيم تعاملهم بعضهم مع البعض الآخر هي وضع اختلافاتهم الميتافيزيقية جانبا ً، بحيث يبقى العقل العام بمنأى عن مؤثراتها. ان دعوة كهذه تتضمن أن الفريق الذي تصدر عنه يعطي لنفسه الحق في أن يضع سلطته المعرفية محل السلطة المعرفية لأي فريق آخر. من هنا يتضح لماذا تسييس الدين هو خطوة كبرى في اتجاه الغاء سيرورة التفاعل الاجتماعي الحواري، والغاء دور العقل العام معها، ولماذا يشكل، بالتالي، واحدا ً من أهم التحديات التي تواجه محاولة اقامة مؤسسات ديمقراطية عادلة.